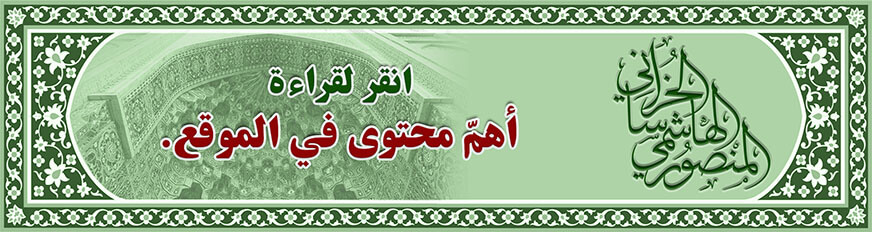نظرًا لأنّ القروض البنكيّة التي فيها شرط ربح أو شرط عمولة كلّها محرّمة عند السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى، ماذا يجب أن يفعل من أخذها وتصرّف فيها بجهالة بعد ما تبيّن له؟ كيف يمكنه أن يطهّر ماله من الرّبا؟
لا إشكال في أنّ أخذ الرّبا وإعطاءه محرّمان جميعًا؛ كما روي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ»[١]، وكان عبد اللّه بن مسعود يقول: «آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ سَوَاءٌ»[٢]، ولا إشكال في أنّ من أخذ الرّبا متعمّدًا فعليه أن يردّه إلى صاحبه ويستغفر اللّه، وأمّا من أعطى الرّبا فلا يستطيع غالبًا أن يستردّ ما أعطاه، ولذلك يكفيه أن يستغفر اللّه، ولا يجب عليه الإسترداد، إلّا أن يستطيع؛ كما روي: «أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ فَتَغَيَّرَ، فَخَرَجَ بِهِ بِلَالٌ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟! فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا»[٣]، وفي رواية أخرى قال: «انْطَلِقْ، فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ»[٤]، ولا إشكال في أنّ آخذ الرّبا يجوز له التصرّف في ماله بعد ردّ الرّبا إلى صاحبه؛ لأنّه قد أخرج الحرام من ماله، و«لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»[٥]، ولكن هل يجوز لمعطي الرّبا أن يتصرّف في المال الذي اقترضه بشرط الرّبا متعمّدًا؟ فيه وجهان:
الأوّل أنّه لا يجوز؛ لأنّ شرط الرّبا حرام، والمال الذي اكتُسب به إنّما اكتُسب بفعل حرام، وهذا يقتضي أن يكون مالًا حرامًا، ولأنّ المقرض إنّما أقرضه بشرط الرّبا، والظاهر أنّه لم يكن راضيًا بالتصرّف في ماله من دون ذلك، وعليه فإنّ التصرّف في ماله إذا كان مع الوفاء بشرطه فهو اكتساب المال بفعل حرام، وإذا لم يكن مع الوفاء بشرطه فهو تصرّف في مال الغير من دون رضاه، فيكون حرامًا في كلّ حال.
الثاني أنّه يجوز؛ لأنّ القرض حلال، وشرط الرّبا فيه شرط باطل في ضمن عقد صحيح، وهو لا يفسد العقد، وعليه يجوز للمقترض بشرط الرّبا أن يتصرّف في مال المقرض ولا يعطيه الرّبا؛ لأنّه أذن بالتصرّف في ماله، وإنّما بطل شرطه، ولم يوجب له حقًّا، وهذا مثل قضيّة بريرة[٦]، إذ سألت عائشة أن تشتريها وتعتقها، ولم يكن أهلها يبيعونها إلّا بشرط أن يكون لهم ولاؤها[٧]، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعائشة: «اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا»، أو قال: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فقبلت عائشة شرطهم، واشترت بريرة، وأعتقتها، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في المسجد: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»[٨]. فاشترت عائشة بريرة وأعتقتها بشرط باطل، وهذا يدلّ على أنّ شرط الرّبا لا يبطل القرض، ولا يحرّم التصرّف في مال المقرض، بل لعلّه ليس بحرام أصلًا.
لكنّ الوجه الأوّل هو أشبه بالصواب؛ لأنّ بطلان الشرط في العقد مفسد له إذا كان هو الباعث الوحيد أو الباعث الرئيسيّ عليه؛ علمًا بأنّ رضى المعاقد منوط به، وقد قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[٩]، والمراد بالرضى ما كان عن علم، ولا عبرة برضى الجاهل؛ لأنّه «غرور»، وهو يفسد العقد. بناء على هذا، فإنّ المقترض بشرط الرّبا، إن كان ناويًا أن لا يفي بالشرط، فقد غرّ المقرض وأخذ ماله بغير رضاه، وإن كان ناويًا أن يفي بالشرط، فإنّ الوفاء به حرام، والحرام لا يفيد الحلال.
أمّا رواية بريرة ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد رأى بعضهم أنّ قوله: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» غلط من الراوي؛ لأنّه لم يرد إلّا في رواية هشام بن عروة، وليس من الممكن أن يأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم امرأته بقبول شرط باطل حرام لتستخلص به مملوك قوم من دون رضاهم، ورأى بعضهم أنّ «لَهُمُ» في قوله: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» هو في معنى «عَلَيْهِمْ»، كما في قول اللّه تعالى: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾[١٠]، والمراد به أن تشترط عائشة أن يكون الولاء لها، ورأى بعضهم أنّ قوله: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» ليس بأمر، ولكنّه توبيخ وتهديد؛ كقول اللّه تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾[١١]، ورأى بعضهم غير ذلك، ومع هذه الإحتمالات لا يمكن الإستناد إليه لتصحيح عقد مبنيّ على شرط باطل حرام.
فالأظهر أنّ المقترض لا يجوز له التصرّف في مال اقترضه بشرط الرّبا متعمّدًا، بل لا بدّ له من ردّه إلى المقرض والإستغفار، إلّا أن يلغي المقرض الشرط، وإن كان المقترض قد تصرّف في المال فليس عليه أن يردّه مع الرّبا المشروط، بل يردّ رأس المال ويستغفر للتصرّف فيه والشرط، ولو كره المقرض؛ لأنّه لا يكره فعله، ولكن يكره ما أنزل اللّه، فلا يرغم اللّه إلّا أنفه، وإن كان المقترض قد حصل على فائدة من المال فليس عليه أن يردّ الفائدة أيضًا؛ لأنّ المقرض قد ظلم نفسه إذ أقرض بشرط باطل، فاستحقّ الحرمان، ولأنّ الإقراض بشرط الرّبا حرام ولا يمكن أن يفيد مالًا حلالًا؛ كما أنّ الإقتراض بشرط الرّبا حرام ولا يمكن أن يفيد مالًا حلالًا، وهذا يعني أنّ الفائدة ليست للمقرض ولا للمقترض، فلا بدّ من دفعها إلى الإمام أو إنفاقها في سبيل اللّه.
هذه توبة لمن اقترض مالًا بشرط الرّبا وتصرّف فيه وحصل منه على فائدة إذا كانت الفائدة معلومة، وإذا كانت الفائدة غير معلومة لكثرتها أو اختلاطها بأمواله، فليدفع إلى الإمام أو ينفق في سبيل اللّه حتّى يعلم أنّها قد خرجت من أمواله، وقد روي عن أهل البيت ما يدلّ على كفاية الخمس في هذه الحال؛ كما روي: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَحَرَامًا، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ، وَلَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَالْحَرَامَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ، وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ»[١٢]، وفي رواية أخرى: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ، أَفَلِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: ائْتِنِي بِخُمُسِهِ، فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»[١٣]، وهو حسن، لولا أنّه خبر واحد مخالف للقاعدة والإحتياط.
هذا كلّه بالنسبة لمن أخذ ربا أو أعطاه وهو يعلم أنّه ربا، وأمّا من أخذ ربا أو أعطاه وهو لا يعلم أنّه ربا، لشبهة أو تقليد، فالظاهر عدم وجوب ردّ المال وفائدته عليه بعد ما جاءه العلم؛ لقول اللّه تعالى في آية الرّبا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[١٤]؛ كما روي عن أبي الربيع الشامي، قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ، قَالَ: أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ، وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ»[١٥]، وذلك لأنّ الرّبا شيء قد يخفى على الناس، وقد خفي على عمر بن الخطاب، حتّى قال: «إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَمِثْلُ كُوَرِهَا»[١٦]، وقال: «ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا»[١٧]، وقال: «إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِّبَا، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا لَنَا، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَاتِ»[١٨]، ولا شكّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيّن الرّبا وسائر ما يحتاج إليه الناس حتّى تقوم الساعة، ولكنّهم لم يحفظوا بعضه، فخفي عليهم، ومن ذلك الرّبا، ولهذا يجري فيهم قول اللّه تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، ولم يكن قولًا جاريًا في الصحابة فقطّ، وهذا تخفيف من اللّه لكي لا يكون عليهم حرج إذا أكلوا الرّبا بجهالة ثمّ تابوا، وقد بيّنه السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى بيانًا مفصّلًا؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:
سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ، فَأَكَلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِلْمُ، مَاذَا يَفْعَلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ رَجُلًا كَافِرًا قَدْ أَسْلَمَ فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَلْيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ، قُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا أَكَلَهُ رِبًا، وَقِيلَ لَهُ أَنَّهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِلْمُ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِمَّنْ تَوَعَّدَهُ اللَّهُ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا يَعُدْ، قُلْتُ: فَلَهُ مَا سَلَفَ؟ قَالَ: لَهُ مَا سَلَفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ رَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، قُلْتُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ إِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا الرِّبَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَؤُوا بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُهُمْ، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[١٩]، قُلْتُ: أَلَيْسَ عَلَيْهِمْ رَدُّ مَا غَصَبُوا أَوْ أَتْلَفُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَإِنْ كَانُوا جَاهِلِينَ؟! قَالَ: إِنَّ الرِّبَا لَيْسَ كَهَذَا، إِنَّهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ.
نعم، إن بقي من الرّبا قسط فليذروه، وإن كانوا جاهلين عند العقد؛ لقول اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[٢٠]؛ فلا يجوز لهم استيفاء أقساطه بعد ما جاءهم العلم، وكذلك إيفاؤها، وإن أدّى تركه إلى فسخ العقد، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[٢١].