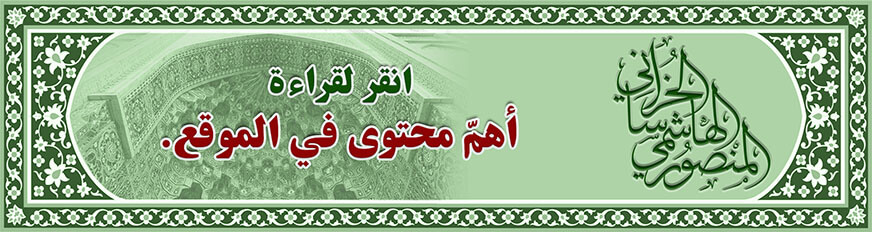ما حكم الحلف بالقرآن؟
حكم الحلف بالقرآن تابع لأمرين:
١ . حكم الحلف بغير اللّه
الظاهر عدم الخلاف بين العلماء في كراهية الحلف بغير اللّه، وإن اختلفوا في أنّها كراهية تحريم أو تنزيه، فللمالكيّة والحنابلة قولان، وجمهور الشافعيّة على أنّها كراهية تنزيه، وجزم ابن حزم بالتحريم، وذلك لأنّ الحلف بالشيء يعتبر تعظيمه، والتعظيم ينبغي أن يكون للّه؛ إذ ليس هناك عظيم في الحقيقة إلا هو، ولما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ»[١]، وفي رواية أخرى: «لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ»[٢]، والحقّ هو التفصيل باعتبار المحلوف به، فإن كان المحلوف به شيئًا معظّمًا في الشرع كالنبيّ والكعبة ونحوهما فمكروه كراهية تنزيه، ولا يبعد إباحته إذا كان الحلف به اعتبارًا لعظمته في الشرع؛ لأنّه يرجع إلى تعظيم اللّه تعالى، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾[٣]، وعليه يحمل أقسام القرآن ببعض الأشياء، فإنّها من آيات اللّه، ولذلك يرجع تعظيمها إلى تعظيمه؛ نظرًا لأنّ الرجل إذا قال ما أعظم خلق اللّه لم يعظّم غير اللّه في الحقيقة، ولكن عظّم اللّه الذي خلقه، وكذلك إذا استعظم السماء والأرض وغيرهما من المخلوقات وهو مؤمن باللّه، خلافًا لما إذا استعظمها وهو كافر، إلا أنّ ذلك أيضًا ترك أولى؛ لأنّ الحلف باللّه أولى من الحلف بخلقه وإن كان باعتبار أنّه خلقه، إلا أن يكون هناك مصلحة في الحلف بذلك، كما هي الحال في أقسام القرآن ببعض الأشياء، فإنّ فيها مصلحة كبيرة، وهي الحثّ على تأمّل هذه الأشياء للتنبّه على ما فيها من دلائل التوحيد والمنافع الدّينيّة أو الدّنيويّة.
هذا فيما كان المحلوف به شيئًا معظّمًا في الشرع، وأمّا إن كان شيئًا غير معظّم في الشرع كالأب والأمّ والولد والحاكم وغير ذلك ممّا يستعظمه الناس بغير اعتبار شرعيّ فمكروه كراهية تحريم؛ لأنّه لا يجوز تعظيم ما لم يعظّمه الشرع أصلًا أو إلى هذه الدّرجة، وإن كان ممّا حقره الشرع كأصنام المشركين فكفر أو نفاق، وعليه يحمل ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»[٤]، كأنّه أراد بغير اللّه ما كان يُعبد من دونه؛ كما روي أنّه قال: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ»[٥]، وقال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»[٦].
٢ . ماهيّة القرآن
هناك خلاف قديم بين المسلمين في ماهيّة القرآن. فيعتقد فريق منهم أنّه غير مخلوق؛ لأنّه كلام اللّه، وهو من صفاته القائمة بذاته، فكأنّهم يعتبرونه جزءًا من الخالق، وفيهم من يقول بقِدمه صراحة، ويعتقد فريق منهم أنّه مخلوق؛ لأنّه لم يكن فكان إذ أنزله اللّه إلى رسوله، وكلا الفريقين قد جاوز الحقّ؛ لأنّ اللّه لم يصف القرآن بأنّه مخلوق أو غير مخلوق، وإنّما وصفه بأنّه «كلام اللّه»، وكذلك لم يصفه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلا بما وصفه اللّه، فمن سمّاه مخلوقًا أو غير مخلوق فقد جاء ببدعة في الدّين، وهذا غير جائز، ولذلك امتنع منه أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا؛ كما روي عن عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد الصادق عليهم السلام أنّهم سئلوا عن القرآن فقالوا: «لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»[٧]، قال البيهقيّ: «هُوَ عَنْ جَعْفَرٍ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ»[٨]، وروى سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ مَنْ قِبَلَنَا، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا يَقُولُونَ، وَلَكِنِّي أَقُولُ إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ»[٩]، وروى الحسين بن خالد، قال: «قُلْتُ لِلرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ، أَخَالِقٌ أَوْ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»[١٠]، وكتب عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام إلى بعض شيعته ببغداد: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ يَفْعَلْ فَقَدْ أَعْظَمَ بِهَا نِعْمَةً، وَإِنْ لَا يَفْعَلْ فَهِيَ الْهَلْكَةُ، نَحْنُ نَرَى أَنَّ الْجِدَالَ فِي الْقُرْآنِ بِدْعَةٌ اشْتَرَكَ فِيهَا السَّائِلُ وَالْمُجِيبُ، فَيَتَعَاطَى السَّائِلُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَيَتَكَلَّفُ الْمُجِيبُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ الْخَالِقُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، لَا تَجْعَلْ لَهُ اسْمًا مِنْ عِنْدِكَ فَتَكُونَ مِنَ الضَّالِّينَ، جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ»[١١]، وبمثل هذا قال جمهور السلف؛ كما قال زهير بن عبّاد: «كَانَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنَ الْمَشَايِخِ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ»[١٢]، وقد حاول بعض الجاهلين تأويل هذا القول، فحرّفوه من موضعه، فقالوا أنّ المراد به أنّ القرآن ليس خالقًا، لكنّه من الخالق بمعنى صفة من صفات ذاته، مع أنّ المراد به الإمتناع من القول بأنّ القرآن خالق أو مخلوق لما في ذلك من الإبتداع في الدّين والخوض فيما لا يعني؛ كما جاء ذلك في الرواية عن موسى بن جعفر وعليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام بصراحة، وروي عن عمّار بن منصور أنّه قال: «كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ، فَمَنْ سَمَّى الْقُرْآنَ بِالْإِسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ بِهِ كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَمَنْ سَمَّاهُ بِاسْمٍ مِنْ عِنْدِهِ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، قَالَهُ عَنْ هَذَا: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[١٣]، فَإِنْ تَأْبَى كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ ﴿يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[١٤]»[١٥]، وروي عن بشر بن الوليد أنّه قال لخليفة مأمون لمّا امتحنه وسأله عن قوله في القرآن: «أَقُولُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ»، فقال: «لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا، أَمَخْلُوقٌ هُوَ؟»، قال: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»، قال: «فَالْقُرْآنُ شَيْءٌ؟» قال: «نَعَمْ»، قال: «فَمَخْلُوقٌ هُوَ؟» قال: «لَيْسَ بِخَالِقٍ»، قال: «فَهُوَ مَخْلُوقٌ»، قَالَ: «مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا»، ثمّ كلّم الخليفة جماعة من وجوه الفقهاء والقضاة فقالوا قريبًا من قول بشر[١٦]، إلا ابن البكّاء، فإنّه زاده بيانًا فقال: «الْقُرْآنُ مَجْعُولٌ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾[١٧]»، فقال الخليفة: «فَالْمَجْعُولُ مَخْلُوقٌ؟»، قال: «نَعَمْ»، قال: «وَالْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟» قال: «لَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ، وَلَكِنَّهُ مَجْعُولٌ»[١٨]، وهذا دليل على أنّهم كانوا يتورّعون عن وصف القرآن بأنّه خالق أو مخلوق لعدم ورود ذلك في القرآن والسنّة، لا للإعتقاد بأنّه جزء من الخالق أو صفة لذاته، وإنّما كرهوا أن يطلقوا عليه المخلوق لما في ذلك من الإيهام والتلبيس، على سبيل قول اللّه تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾[١٩]؛ لأنّ المخلوق قد يُستعمل بمعنى المكذوب، وإلا فمن الواضح أنّ القرآن كلام اللّه، وهو من صفات فعله، وليس من صفات ذاته؛ كما صرّح سبحانه بأنّه «مُحْدَثٌ»[٢٠]، وما كان من ذاته فغير محدَث، كما لا يُنزَل ولا يُذهَب ولا يُنسَخ ولا يُخصَّص ولا يوصف بأنّه عربيّ، ولا شكّ أنّ الكلام غير المتكلّم، وهو من فعله الذي يفعله إذا يشاء ويتركه إذا يشاء، وهذا واقع محسوس لا ينكره إلا كلّ أحمق، وحاشا للسلف الصالح أن كانوا قد أنكروه؛ كما روي التصريح به عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام إذ قال: «إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مُحْدَثٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَغَيْرُ أَزَلِيٍّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا شَيْءَ غَيْرَ اللَّهِ مَعْرُوفٌ وَلَا مَجْهُولٌ، كَانَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مُتَكَلِّمَ وَلَا مُرِيدَ وَلَا مُتَحَرِّكَ وَلَا فَاعِلَ، جَلَّ وَعَزَّ رَبُّنَا، فَجَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ مُحْدَثَةٌ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ مِنْهُ، جَلَّ وَعَزَّ رَبُّنَا، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فِيهِ خَبَرُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ، أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»[٢١].
بناء على هذا، فإنّ القرآن غير اللّه، وإن كان من فعله وقد عُظّم في الشرع، ولذلك يكره الحلف بالقرآن كراهية تنزيه، والقاعدة أنّ الحلف لا ينعقد إلا باللّه، ولا كفّارة في حنثه إلا إذا انعقد، وذلك لأنّ المتبادر من الحلف في القرآن هو الحلف المباح في الشرع، وهو الحلف باللّه، دون الحلف الحرام أو المكروه، وهو الحلف بغير اللّه؛ كما قال في غير واحدة من الآيات: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾[٢٢]، وإليه ينصرف حكمه في الكفّارة، ولا شكّ أنّ الأصل براءة الذمّة وعدم وجوب الكفّارة. مع ذلك، يجب القيام بما حلف عليه مطلقًا من باب الوفاء بالعهد، وإن لم يكن فيه كفّارة؛ كما إذا قال لرجل: «لعمري سأقوم لك بكذا وكذا»؛ فإنّه عهد، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[٢٣].