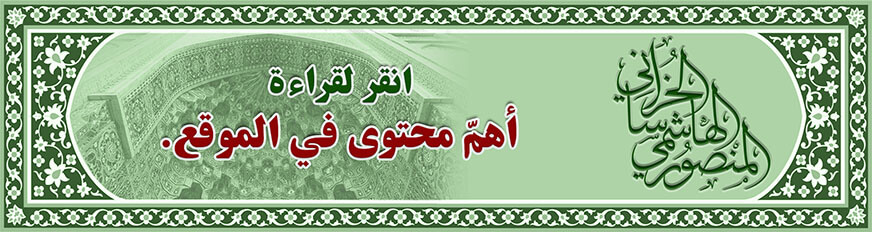ما رأي السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني في نوروز الذي يهتمّ به كثير من المسلمين في إيران وأفغانستان وطاجيكستان وتركيا وغيرها، ويتّخذونه عيدًا؟
«العيد» في الإسلام يوم يجب تعظيمه بفرح وعمل عباديّ خاصّ، وهو الفطر والأضحى؛ كما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا»[١]، وليس منه «نوروز»، ولا «مهرجان»، اللذان كان أهل الجاهليّة يعظّمونهما بغير علم ولا هدًى ولا كتاب منير؛ كما روي عن أنس بن مالك أنّه قال: «كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ»[٢]، وإنّما استحقّا التعظيم من دونهما لفراغ الناس فيهما ممّا فرض اللّه عليهم وقرّبهم إليه من الطاعات والعبادات؛ لأنّ هذا ما يفرح به العاقل، دون ذهاب فصل ومجيء فصل آخر من السنة، ممّا لا ينفع ولا يضرّ في حدّ ذاته، أو ينفع في الدّنيا فقطّ؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:
سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾[٣]، فَقَالَ: هُمَا الْفِطْرُ وَالنَّحْرُ، فَقُلْتُ: فَسِّرْ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَقَالَ: كَانَ لِلنَّاسِ يَوْمَانِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ يَفْرَحُونَ بِهِمَا لِمَا يَجْمَعُونَ فِيهِمَا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، وَهُمَا النَّيْرُوزُ وَالْمِهْرَجَانُ، فَأَبْدَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَهُمَا الْفِطْرُ وَالنَّحْرُ، فَبِهِمَا فَلْيَفْرَحُوا، فَقَدْ يَجْمَعُونَ فِيهِمَا ثَوَابَ الْآخِرَةِ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ ثَوَابِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾.
هذا استنباط بديع من هذا العالم العظيم، وممّا يدلّ أيضًا على كراهية اتّخاذ هذين اليومين عيدًا قول اللّه تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾[٤]؛ لأنّ الفرح بهذين اليومين إنّما هو لانبساط الرزق فيهما، وقد ذمّ اللّه تعالى قومًا يفرحون بالحياة الدنيا، وكذلك قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾[٥]؛ لأنّه قد نسب الإعجاب بنبات الغيث -يعني التلهّي به- إلى الكفّار، واستحقر اللعب واللّهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، وكلّ ذلك حاصل في هذين اليومين، ومثلهما في الدلالة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾[٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾[٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾[٨]، وقوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾[٩]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾[١٠]؛ فهذه الآيات كلّها تدلّ على كراهية الفرح بالحياة الدّنيا، ولا شكّ أنّ من أبرز مصاديقه الفرح بما يتوفّر في الإعتدالين الربيعيّ والخريفيّ من ثمرات الأرض وأرباح المكاسب الباعث على اتّخاذهما عيدًا.
كيفما كان، فمن الواضح أنّ النيروز أو المهرجان ليس من الأيّام التي اعتبرها الإسلام عيدًا، ولذلك من كان يريد اتّباع الإسلام فليس له أن يعتبره عيدًا؛ لأنّه إذا فعل ذلك فقد خالف الإسلام، وعمل عملًا ليس عليه أمره، وقد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[١١]، ولذلك لم يعتبره أحد من الصحابة عيدًا، إلّا معاوية؛ فإنّه أوّل من فعل ذلك[١٢]، وأهدى فيه هدايا كثيرة، وقبضها[١٣]، ويقال أنّ أوّل من فعل ذلك الوليد بن عقبة في زمن عثمان[١٤]، وهو الذي سمّاه اللّه في كتابه «فاسقًا»[١٥]، ولم يكن عليّ يقبل هديّة النيروز[١٦]، إلّا إذا أهداها إليه أهل الذمّة من المجوس لكون ذلك من دينهم؛ كما روي أنّ قومًا من الدهاقين أهدوا إليه جامات فضّة فيها الأخبصة، فقال: «مَا هَذَا؟» فقالوا: «يَوْمُ نَيْرُوزٍ»، فقال: «نَيْرُوزُنَا كُلُّ يَوْمٍ»، على وجه الخبر، فأكل الخبيص، وأطعم جلساءه، وقسّم الجامات بين المسلمين، وحسبها لهم في خراجهم[١٧]، وفي رواية أخرى أنّه قال: «نَيْرِزُونَا كُلَّ يَوْمٍ»، على وجه الأمر[١٨]، وأيّهما كان فإنّه يدلّ على كراهية تخصيص هذا اليوم بمثل هذا العمل؛ كما قال البيهقي (ت٤٥٨هـ) في شرحه: «فِي هَذَا كَالْكَرَاهَةِ لِتَخْصِيصِ يَوْمٍ بِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلْهُ الشَّرْعُ مَخْصُوصًا بِهِ»[١٩]، وقال الحكيم الترمذي (تنحو٣٢٠هـ): «كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَعْبَأَ بِهِ»[٢٠].
فلمّا ملك معاوية اهتمّ بأمر النيروز والمهرجان، وتبعه على ذلك خلفاؤه، حتّى ملك عمر بن عبد العزيز، فنهى أن يُذهب إليه في النيروز والمهرجان بشيء[٢١]، وحُكي أنّه لمّا قدم بالنيروز والمهرجان على سليمان بن عبد الملك، صُبّت له صنوف الهدايا في آنية الذهب، فكلّما مرّ بعمر صنف منها قال له سليمان: «كَيْفَ تَرَى هَذَا يَا ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟!» فقال: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فقال له سليمان: «فَآللَّهُ، لَوْ وَلِيتَهُ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِيهِ؟» قال: «اللَّهُمَّ أَقْسِمُهُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ»، فقال سليمان: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»[٢٢]، فلمّا ولي عمر رفع رسم هدايا النيروز والمهرجان، حتّى ردّه يزيد بن عبد الملك على ما كان عليه[٢٣]. ثمّ جرى الأمر على ذلك إلى سنة ٢٨٤، ففي هذه السنة منع المعتضد العبّاسيّ الناس من عمل ما كانوا يعملونه في النيروز من صبّ الماء وإيقاد النار وغير ذلك، فنودي في البلدان أن لا يهتمّ الناس بأمر النيروز، ثمّ أطلق لهم ذلك، فكانوا يصبّون الماء على المارّة، وتوسّعوا في ذلك وغلوا، حتّى جعلوا يصبّون الماء على الجند وأصحاب الشرطة وغيرهم![٢٤] فاللّه يعلم ما دعا الفاسق إلى المنع من ذلك مرّة! فقد أهدت إليه زوجته قطر الندى في النيروز هديّة كان فيها عشرون صينيّة ذهب، في عشرة منها مشام عنبر وزنها أربعة وثمانون رطلًا، وعشرون صينيّة فضّة، في عشرة منها مشام صندل زنتها نيّف وثلاثون رطلًا، وخمس خُلع وشي قيمتها خمسة آلاف دينار، وعملت شمامات ليوم النيروز بلغت النفقة عليها ثلاثة عشر ألف دينار![٢٥]
كذلك كان النيروز يوم التترّف والتلذّذ واتّباع الشهوات عند الجبابرة من بني أميّة وبني عبّاس، كما كان عند الأكاسرة قبل الإسلام، بل يقال أنّه كان عيدًا عند فرعون؛ كما قال مقاتل بن سليمان (ت١٥٠هـ) في «تفسيره»: «قَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ﴾[٢٦]، يَعْنِي يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ، ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾[٢٧]»[٢٨]. أمّا الأئمّة والصالحون من أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا مخالفين لذلك دائمًا؛ كما روي أنّ المنصور العبّاسيّ تقدّم إلى موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يُحمل إليه، فقال موسى: «إِنِّي قَدْ فَتَّشْتُ الْأَخْبَارَ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَجِدْ لِهَذَا الْعِيدِ خَبَرًا، وَإِنَّهُ سُنَّةٌ لِلْفُرْسِ، وَمَحَاهَا الْإِسْلَامُ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نُحْيِيَ مَا مَحَاهُ الْإِسْلَامُ»، فقال المنصور العبّاسيّ: «إِنَّمَا نَفْعَلُ هَذَا سِيَاسَةً لِلْجُنْدِ»[٢٩]، وروي أنّ محمّد بن القاسم بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ أُدخل على المعتصم في يوم النيروز، وأصحاب السّماجة بين يديه يلعبون، والفراغنة يرقصون، فلمّا رآهم محمّد بكى، ثمّ قال: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى تَغْيِيرِ هَذَا وَإِنْكَارِهِ»، فجعلت الفراغنة يحملون على العامّة، ويرمونهم بالقذر والميتة، والمعتصم يضحك، ومحمّد يسبّح ويستغفر اللّه ويحرّك شفتيه يدعو عليهم[٣٠]، ومن الواضح أنّه لا يجوز للمؤمنين الإستنان بسنّة الفراعنة والأكاسرة وسائر الجبّارين؛ كما لا يجوز لهم التشبّه بالمجوس الذين كانوا يعظّمون النيروز والمهرجان بغير علم ولا هدًى ولا كتاب منير؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾[٣١]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[٣٢]، وقال: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾[٣٣]، وقد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه نهى عن التشبّه بغير المسلمين، وقال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»[٣٤]، وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا»[٣٥]، وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا»[٣٦]، رواه حذيفة، وجابر، وابن عبّاس، وأنس، وابن عمر، وأبو هريرة، وعبد اللّه بن عمرو، وغيرهم، وقال في حديث اللحية والشوارب: «لَا تَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ»[٣٧]، وروي عن أهل البيت أنّهم قالوا: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ: لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي، وَلَا تَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي، وَلَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي، -وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَلَا تُشَاكِلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي- فَتَكُونُوا أَعْدَائِي، كَمَا هُمْ أَعْدَائِي»[٣٨]، وقالوا في حديث الشطرنج: «دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا، لَعَنَهَا اللَّهُ»[٣٩]، وروي عن بعض الصحابة أنّه قال: «مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ، وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ، حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[٤٠]، وروي مرفوعًا في «المشيخة البغدادية» لأبي طاهر السلفيّ (ت٥٧٦هـ)[٤١]، وروي عن الحسن البصريّ أنّه قال: «مَا لَكُمْ وَالنَّيْرُوزُ؟! لَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلْعَجَمِ»[٤٢]، وقال الحكيم الترمذيّ: «إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى مَنْ تَشَبَّهَ بِأَهْلِ الْبِطَالَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَبِالْمُلُوكِ الْفَرَاعِنَةِ الَّذِينَ تَلَذَّذُوا بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مُلْهِي مُطْرِبٌ، مَعَ الْغِنَاءِ وَالْجَوَارِي، وَالسَّمَاعِ عَلَى شَاطِئِ الْأَنْهَارِ، فِي تِلْكَ الْخُضَرِ وَنُورِ الرَّبِيعِ، وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زِينَتَهَا وَزُخْرُفَهَا فِي أَيَّامِ النَّيْرُوزِ، مَعَ طِيبِ الْهَوَاءِ وَسَجْسَجَةِ الْجَوِّ، تَنَزَّهُوا فِي نُزْهَةِ الدُّنْيَا، وَتَنَعَّمُوا بِالْأَلْوَانِ، وَقَضَوُا الْمُنَى وَالشَّهَوَاتِ، وَحَفَّ بِهِمُ الْمَعَازِفُ، وَرَكِبُوا الْمَرَاجِيحَ، فَتَعَجَّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدِّنْيَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾[٤٣]»[٤٤].
الحاصل أنّه لا يجوز اتّخاذ النيروز عيدًا، بجعله يوم اللّهو واللعب وشراء الأمتعة الجديدة وأمثال ذلك، أو تخصيصه بعمل صالح مثل تنظيف الدّار وصلة الأرحام وزيارة الجيران وإطعام الطعام والصوم والإغتسال وأمثال ذلك. نعم، لا بأس بهذه الأعمال في الشهر الأوّل من الربيع لمن يعملها في سائر الشهور أيضًا؛ لأنّ الحرام التخصيص؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:
كُنَّا مَعَ الْمَنْصُورِ، فَاسْتَأْذَنَهُ رِجَالٌ مِنَّا لِلْخُرُوجِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمُ النَّيْرُوزِ، فَنُطْعِمُ أَهْلِينَا، وَنَصِلُ أَرْحَامَنَا، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَمَّا خَرَجُوا، قُلْتُ لَهُ: أَأَذِنْتَ لَهُمْ أَنْ يُعَظِّمُوا النَّيْرُوزَ؟! فَقَالَ كَمُغْضَبٍ: مَاذَا تُرِيدُ؟! أَتُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ: لَا تُطْعِمُوا أَهْلِيكُمْ، وَلَا تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ؟! لَا وَاللَّهِ، لَا أَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ! فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَيْهِ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهُمْ: أَأَطْعَمْتُمْ أَهْلِيكُمْ، وَوَصَلْتُمْ أَرْحَامَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَحْسَنْتُمْ، فَافْعَلُوهُمَا فِي كُلِّ شَهْرٍ! فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا نُخَالِفُكَ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَالْحَقُّ مَعَكَ وَالْخَطَأُ مِنَّا.
هذا كان مراد عليّ عليه السلام بقوله لمن أهدى إليه شيئًا في النيروز: «نَيْرِزُونَا كُلَّ يَوْمٍ»، وفي رواية أخرى: «فَنَيْرِزُوا كُلَّ يَوْمٍ»، وفي رواية أخرى: «فَاصْنَعُوا كُلَّ يَوْمٍ نَيْرُوزًا»، وفي رواية أخرى: «فَنَيْرِزُوا إِنْ قَدَرْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ»؛ يعني تهادوا وتواصلوا في اللّه غير مقتصرين على هذا اليوم. هذا بالنسبة للأعمال الصالحة والمباحة التي يعملونها في هذا اليوم، وأمّا الأعمال الباطلة والخرافيّة التي يعملها السفهاء تشبّهًا بالمجوس، مثل إيقاد النار وصبّ الماء وجمع السّينات السبع والخروج في اليوم الثالث عشر وأمثال ذلك، فلا تجوز مطلقًا، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾[٤٥].
إنّهم يروون عن أهل البيت حديثًا في تعظيم النيروز وتخصيصه بغُسل وصوم وصلاة وغير ذلك، يروونه عن المعلّى بن خُنيس عن جعفر الصادق، وقد جاء فيه: «مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلَّا وَنَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ الْفَرَجَ، لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا وَأَيَّامِ شِيعَتِنَا، حَفِظَتْهُ الْعَجَمُ، وَضَيَّعْتُمُوهُ أَنْتُمْ»، وجاء فيه: «إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سَأَلَ رَبَّهُ كَيْفَ يُحْيِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ خَرَجُوا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ الْفُرْسِ، فَعَاشُوا، وَهُمْ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، فَصَارَ صَبُّ الْمَاءِ فِي النَّيْرُوزِ سُنَّةً»، وجاء فيه: «إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ فَاغْتَسِلْ، وَالْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ، وَتَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طِيبِكَ، وَتَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَإِذَا صَلَّيْتَ النَّوَافِلَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ <إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ>، وَفِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ <قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ>، وَفِي الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ <قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ>، وَفِي الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَتَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الرَّكَعَاتِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ، وَتَدْعُو فِيهَا، يُغْفَرُ لَكَ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً». فما رأي سيّدنا المنصور في هذا الحديث؟
أخبرنا بعض أصحابنا، قال: «قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ بَلَغَكَ فِي النَّيْرُوزِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا قَوْلَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: <نَيْرُوزُنَا كُلُّ يَوْمٍ>»، وهذا كالصّريح في أنّه لم يصحّ عن أهل البيت في هذا الباب شيء غير ذلك. أمّا حديث المعلّى بن خُنيس فضعيف مرسل، بل موضوع بلا شكّ؛ فإنّه لا يوجد له إسناد إلّا في الكتاب المسمّى بـ«بحار الأنوار» للمجلسيّ (ت١١١١هـ)، وفيه كلّ بلاء، وقد جاء فيه: «أقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة: <رَوَى فَضْلُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ -يَعْنِي الرَّاوَنْدِيَّ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الدُّورِيسْتِيِّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُونِسِيِّ الْقُمِّيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّائِغِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ النَّيْرُوزِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَتَعْرِفُ هَذَا الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَذَا يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْعَجَمُ، وَتَتَهَادَى فِيهِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الَّذِي بِمَكَّةَ، مَا هَذَا إِلَّا لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَفْهَمَهُ، قُلْتُ: يَا سَيِّدِي، إِنَّ عِلْمَ هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِيشَ أَمْوَاتِي وَتَمُوتَ أَعْدَائِي>»، فذكر حديثًا طويلًا في فضل النيروز يشتمل على أساطير المجوس وعباراتهم[١]، ثمّ استشهد عليه بما قال ابن فهد الحلّيّ (ت٨٤١هـ) في «المهذّب البارع»، قال: «ممّا ورد في فضل النيروز ما حدّثني به المولى السيّد المرتضى العلامة بهاء الدّين عليّ بن عبد الحميد النسابة -دامت فضائله- رواه بإسناده إلى المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه السلام»![٢] فأوّل ما في هذا الإسناد قول المجلسيّ: «رأيت في بعض الكتب المعتبرة»؛ فإنّه كذب بلا شكّ؛ لأنّ الكتب المعتبرة معروفة بأسمائها ومؤلّفيها، وهي متاحة للناس، فلو كان رآه في بعضها لذكره بصراحة، وكان لغيره أن يراه مثله، فاللّه أعلم أين رآه، وكذلك ابن فهد الحلّيّ؛ فإنّه لم يذكر إسناد شيخه عليّ بن عبد الحميد! ثمّ في هذا الإسناد عيوب فاحشة بيّنها بعض المحقّقين من الشيعة أنفسهم بما أغنانا عن بيانها، فقال: «الرواية ضعيفة، لجهالة الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها المجلسيّ، وجهالة طريق فضل اللّه الراونديّ المتوفّى سنة ٥٧٠ إلى كتب الدوريستيّ في القرن الخامس الهجري؛ لأنّ بينهما قرنًا من الزمن، وفقدان كتب الدوريستيّ للتحقيق من وجود الرواية فيها يُبقي الشكّ قائمًا في صحّة نسبة الرواية إلى كتبه؛ كما أنّ هذه الرواية لم ينقلها أحد من معاصري الدوريستيّ؛ أضف إلى ذلك عدم ثبوت نسبتها لفضل اللّه الراونديّ لفقدان كتابه أيضًا، ولو كانت بهذه الأهمّيّة التي ذكرها المجلسيّ لذُكرت، أو نُقل جزء منها في كتب الحديث، ولمّا كان ظهور الرواية في القرن الثامن على يد عليّ بن عبد الحميد النيليّ في عصر السيطرة المغوليّة التي ساد في ظلّها الإهتمام بالتنجيم والسّحر والتصوّف وإحياء اللّغة الفارسيّة وأيّام الفُرس وأعيادهم وفلسفتهم، جاز لنا أن نحكم بأنّها من موضوعات تلك العصر، وتُنسب إلى المعلّى عن الإمام الصادق عليه السلام بسند واهٍ فيه من المجاهيل أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ المونسيّ القمّيّ، وأحمد بن محمّد بن يوسف، وحبيب الخير، الذين لم يكن لهم ذكر في كتب الرجال، ولم نجد لهم غير هذه الرواية في كتب الحديث، ومن الضّعفاء محمّد بن الحسين الصائغ، وأبوه الذي لم أجد له ذكرًا في كتب الرجال والحديث. إذًا الرواية مجهولة المصدر، مرسلة الإسناد من فضل اللّه الراونديّ -على فرض ثبوتها في كتبه- إلى الدوريستيّ، وفي سلسلة السند أربعة مجاهيل ليس لهم ذكر في كتب الرجال والتراجم، ولم يكن لهم رواية غير هذه، وضعيف واحد، والزمن المقطوع به في ظهور الرواية عصر الدولة المغوليّة على يد النيليّ، ومنه نقل ابن فهد الحلّيّ، ومن ابن فهد وكتب معتبرة -كما وصفها المجلسيّ- نقلها المجلسيّ في البحار، وأوجد لها تفسيرات وتخريجات، وقطّع الخبر بحسب أبواب بحار الأنوار، حتّى انتشرت تلك الرواية في بحاره وغيره»[٣]، ثمّ قال: «فالرواية موضوعة من سندها وسياقها وتفاصيلها وتاريخ ظهورها، وضعها المنجّمون وأصحاب الفأل»[٤]، انتهى قوله، والعجب ما أفتى به فقهاء الشيعة من استحباب غُسل النيروز وصومه وصلاته استنادًا إلى هذه الرواية الموضوعة وتقليدًا لبعضهم البعض، والأعجب أنّهم ينسبونها إلى «مصباح المتهجّد» لأبي جعفر الطوسي (ت٤٦٠هـ)، مع أنّها غير موجودة فيه! نعم، يوجد في مختصره المعروف بـ«المصباح الصغير» ملحقان أحدهما هذا: «رَوَى الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ فَاغْتَسِلْ، وَالْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ، وَتَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طِيبِكَ، وَتَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَإِذَا صَلَّيْتَ النَّوَافِلَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَفِي الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَتَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الرَّكَعَاتِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ، وَتَدْعُو فِيهَا، يُغْفَرُ لَكَ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً»[٥]، فكأنّهم فُتنوا بهذا، مع أنّه ليس من الكتاب، وقد أُلحق به، واللّه أعلم من ألحقه؛ كما نبّه عليه محقّق الكتاب في مقدّمته، فقال: «وردت في أكثر النسخ بعد ختام الكتاب أدعية شتّى؛ منها <دعاء يوم النيروز، نيروز الفُرس>، وظنّ بعضهم أنّها من الشيخ الطوسيّ مؤلّف الكتاب، وقد ألحقها بعد إتمامه، والذي يظهر من سياق الكتاب وبناء الشيخ على أنّه مجرّد تلخيص للأصل فقطّ ولم يضف عليه شيئًا معيّنًا له، أنّ هذه الملحقات هي من مالكي النسخ أو النسّاخ، لا من الشيخ، حيث وردت هذه الإضافات بعد عبارة الشيخ في نهاية تلخيصه»[٦]، والظاهر أنّ أوّل من وقع في هذا الخطأ ابن إدريس (ت٥٩٨هـ)؛ فإنّه قال في «السرائر»: «قال شيخنا أبو جعفر في مختصر المصباح: ويستحبّ صلاة أربع ركعات، وشرح كيفيّتها في يوم النيروز نوروز الفرس»[٧]، وهذا يدلّ على أنّ الرواية وُضعت قبل ابن إدريس أو في زمانه، ولم تظهر في القرن الثامن على يد عليّ بن عبد الحميد النيليّ، خلافًا لما زعم المحقّق، إلّا إذا كان مراده تلك التفاصيل التي لا توجد في ملحقات المصباح الصغير، والأقرب عندنا أنّ الرواية كانت موجودة في بعض كتب الراونديّ (ت٥٧٠هـ)، كما نقله المجلسيّ، فمنه أخذها بعض النسّاخ، فألحقها بالمصباح الصغير، فرآها ابن إدريس (ت٥٩٨هـ) فيه، فزعم أنّها من الطوسيّ، وهي من موضوعات الراونديّ، أو بعض من كان بينه وبين الدوريستيّ، أو بعض من أسندها إليه الدوريستيّ من الضعفاء والمجاهيل، وليس من المحال كونها من الطوسيّ أيضًا؛ لأنّه لم يكن معصومًا مع علمه وفضله، وقد ذكر النجاشيّ (ت٤٥٠هـ) في ترجمة نصر بن عامر السّنجاريّ، وهو من شيوخ الحسين بن عبيد اللّه الغضائري (ت٤١١هـ)، أنّ من كتبه «كتاب ما روي في يوم النوروز»[٨]، فلعلّ الرواية كانت فيه، فأخذها منه الطوسيّ، وكتبها في حاشية المصباح الصغير بغير إسناد، وإن كان ذلك بعيدًا جدًّا؛ لأنّ الطوسي لم يكن له طريق إلى نصر بن عامر، بل لم يعرفه؛ كما لم يذكره في الرجال، ولا في الفهرست، ولم يرو عنه حديثًا في كتبه، واللّه أعلم.