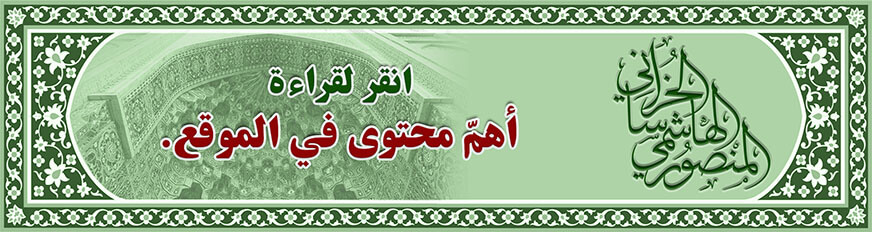ماذا تعني الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن؟ يعتقد بعض الناس أنّها من أسرار القرآن التي لا سبيل إلى معرفتها، ويعتقد بعضهم أنّ كلّ حرف من هذه الحروف رمز إلى كلمة؛ كما أنّ «ن» رمز إلى «النور»، و«ق» رمز إلى «القدير»، و«حم» رمز إلى «الحميد المجيد»، وهكذا. ما رأي العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حول هذه التفاسير؟
ليس في القرآن شيء لا سبيل إلى معرفته؛ لأنّه ﴿كِتَابٌ مُبِينٌ﴾[١]، و«المبين» ما هو واضح لا إبهام فيه، وقد أنزله اللّه للنّاس جميعًا، ويسّره لذكرهم، ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾[٢]؛ كما قال: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾[٣]، وقال: ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾[٤]، وقال: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ﴾[٥]، وقال: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾[٦]، وقال: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾[٧]، ومن اللغو أن يخاطب اللّه النّاس بما لا سبيل لهم إلى معرفته؛ كما جاء عن أهل البيت أنّهم قالوا: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ»[٨]، فلو أراد أن يسرّ إلى نبيّه شيئًا لم ينزله في الكتاب الذي أنزله للنّاس جميعًا؛ لأنّه نقض للغرض. هذا كلّه يدلّ على أنّ القرآن كلّه قابل لفهم النّاس، وليس فيه ما لا سبيل لهم إلى معرفته؛ كما يدلّ على أنّ تفسير حرف أو كلمة منه بما لا يعرفه أهل اللغة هو تفسير بالرأي، وقد جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ»[٩]، وقال: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[١٠]، وذلك لأنّه قول على اللّه بغير علم، وافتراء عليه، وقد نهى اللّه عن ذلك أشدّ نهي فقال: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[١١]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾[١٢].
إذا علمت ذلك فاعلم أنّه ليس للحروف المقطعة معنى معيّن عند أهل اللغة؛ لأنّهم لم يقولوا مثلًا أنّ «ن» يعني «النور»، و«ق» يعني «القدير»، و«حم» يعني «الحميد المجيد»، ولذلك يمكن القول أنّ هذه الحروف ليس لها أيّ معنى معيّن، وبالتالي فإنّ التفاسير الباطنيّة التي تخرق لها المعاني كلّها ظنون وأوهام باطلة لا أصل لها؛ كما اعترف بذلك ابن العربيّ (ت٥٤٣هـ) فيما حكي عنه فقال: «مِنَ الْبَاطِلِ عِلْمُ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ، وَقَدْ تَحَصَّلَ لِي فِيهَا عِشْرُونَ قَوْلًا وَأَزْيَدُ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِعِلْمٍ، وَلَا يَصِلُ مِنْهَا إِلَى فَهْمٍ»[١٣]، وهو كما قال، ولكنّه لا يعني عدم وجود فائدة لهذه الحروف؛ لأنّ اللّه لا يصدر منه حرف بلا فائدة، وفوائدها عند السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى ما يلي:
١ . اختبار الملك الصوت قبل الشروع في وحي السورة، وهذه فائدة لطيفة كشف عنها السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:
قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: الف لام ميم؟! قَالَ: ذَلِكَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ إِذَا يَتَكَلَّمُ بِالْمِجْهَارِ، فَيَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: الْوَاحِدُ، الْإِثْنَانِ، الثَّلَاثَةُ، لِيَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْتَ بَالِغٌ، وَلِيَنْصُتَ السَّامِعُ! قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ سِرٌّ أَسَرَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ، قَالَ: لَوْ كَانَ سِرًّا لَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ لِلنَّاسِ؟! ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَهُوَ بَيَانٌ لِلنَّاسِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾[١٤].
٢ . تنبيه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على شروع الوحي ليتهيّأ لتلقّيه عندما كان مشغولًا، وقد أشار إلى هذه الفائدة بعض المحقّقين من العلماء، وحكي عن الحوفيّ (ت٤٣٠هـ) أنّه قال: «الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَنْبِيهَاتٌ جَيِّدٌ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامٌ عَزِيزٌ وَفَوَائِدُهُ عَزِيزَةٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَرِدَ عَلَى سَمْعٍ مُتَنَبِّهٍ، فَكَانَ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَوْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَالَمِ الْبَشَرِ مَشْغُولًا، فَأَمَرَ جِبْرِيلَ بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ نُزُولِهِ: <الم> وَ<الر> وَ<حم> لِيَسْمَعَ النَّبِيُّ صَوْتَ جِبْرِيلَ، فَيُقْبِلَ عَلَيْهِ وَيُصْغِيَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا لَمْ تُسْتَعْمَلِ الْكَلِمَاتُ الْمَشْهُورَةُ فِي التَّنْبِيهِ كَأَلَا وَأَمَا لِأَنَّهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ فِي كَلَامِهِمْ، وَالْقُرْآنُ كَلَامٌ لَا يُشْبِهُ الْكَلَامَ، فَنَاسَبَ أَنْ يُؤْتَى فِيهِ بِأَلْفَاظِ تَنْبِيهٍ لَمْ تُعْهَدْ لِتَكُونَ أَبْلَغَ فِي قَرْعِ سَمْعِهِ»[١٥].
٣ . حمل الناس على السكوت والإستماع قبل الشروع في تلاوة السورة، وذلك لأنّ الكفّار كانوا يضجّون ويلغون، ولا يستمعون؛ كما أخبر اللّه عن ذلك فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾[١٦]، فإذا سمعوا هذه الحروف سكتوا واستمعوا تعجّبًا، وربما أدّى هذا السكوت والإستماع إلى هدايتهم؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[١٧].
٤ . تنبيه الناس على أنّ القرآن الذي لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، هو مؤلّف من هذه الحروف البسيطة التي يعرفونها ويستعملونها.
هذه هي الفوائد الأربعة التي يراها السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى للحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وقد أخبرنا بعض أصحابه، قال: «سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: أَصْوَاتٌ مِنَ الْمَلَكُوتِ سَمِعَهَا النَّبِيُّ قَبْلَ انْتِظَامِ الْوَحْيِ»، والظاهر أنّه يرجع إلى بعض هذه الفوائد أو كلّها، وإن كان من المحتمل أن يكون وجهًا آخر، بمعنى أنّ الوحي في بدئه كان له أحيانًا أصوات مختلفة مثل أصوات التهجّي، وليس هذا بغريب؛ فقد روي أنّهم سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كيف يأتيه الوحي، فقال: «يَأْتِينِي أَحْيَانًا لَهُ صَلْصَلَةٌ كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيَنْفَصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ، وَذَلِكَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَيَأْتِينِي أَحْيَانًا فِي صُورَةِ رَجُلٍ، فَيُكَلِّمُنِي كَلَامًا، فَأَعِي مَا يَقُولُ»[١٨]، وروي عن عبد اللّه بن مسعود قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانَ»[١٩]، وفي رواية أبي هريرة: «لِقَوْلِهِ صَوْتٌ كَصَوْتِ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا»[٢٠]، والظاهر أنّه كان في بدء الوحي قبل أن ينتظم الكلام، واللّه أعلم.